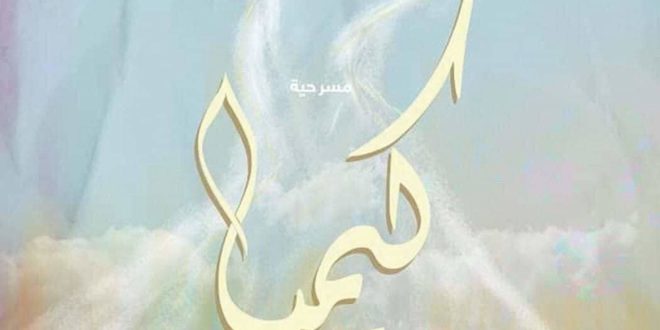يقارب عرض «كيميا» لمخرجه «عجاج سليم» الذي أعدّه عن نص «مجالات مغناطيسية» للكاتب الروسي «ألكسندر أوبرازتسوفي» مسرحيات العبث التي نجمت عن الحروب، وما خلَّفته من إحساس الإنسان المُزمن بالقلق واليأس في عالم لا معنى له، حيث يتحوَّل وجود الإنسان إلى سؤال شائك، والإجابة عنه بحاجة إلى جرأة ما بعدها جرأة، بغية إضفاء مغزى لذاك الوجود، ولاسيما عندما تتحرر إرادته من الأعباء الواقعية التقليدية، ويصبح غير خاضع لضرورات المجتمع، بل لضروراته هو ذاته، كجزء صغير من هذا الكون المُركَّب، فرادَتُهُ تكمن في مدى ممارسته لإرادته وقدرته على الابتعاد أكثر والنظر إلى نفسه من نقطة أبعد.
تتأسس الحكاية في «كيميا» على علاقة انجذاب غريبة بين «رجل.. زامل الزامل» مع «امرأة.. علا السعيد» على واحد من أرصفة المدينة، بعدما دخلا ضمن مجال مغناطيسي جعل من انفصالهما أمراً غير مُستطاع، والأصعب أنه مستهجن من كل من حولهما، فالرجل متزوج وخاضع لسلطة «زوجته.. نجاح مختار» إلى حد بعيد، منذ وجدا نفسيهما وحيدين في الجامعة بعد انفصال كل منهما عن شريكه، وجاء زواجهما رد فعل من دون شغف بالعلاقة، أما المرأة فذاهبة من صالون التجميل إلى عُرسِها، من «شاب.. طارق نخلة» لا تحبه، على عكسه تماماً، فهو يراها فتاة أحلامه التي تعلَّق بها منذ طفولته، لكن الحالة الفيزيائية التي وقعت في شركها، جعلتها لا تستطيع دخول القفص الذهبي من دون شريك ثان، لا يلبث برغم غرابة الموقف والتوترات الدرامية في العلاقة أن يتحول إلى صديق ومن ثم حبيب يبادلها الحب ذاته، رغم رفض تصديق هذه الحدوتة من قبل الكثيرين، وكأن هذين الإنسانين بعدما قام كل منهما بتحديد خيار حاسم ومصيري يتعلق بمسار حياته المستقبلية اكتسب هوية جديدة، راداً لذاته كرامتها ومعنى وجودها، مُزيلاً التعارض الذي كان قائماً بينه كإنسان وبين حياته، حتى بعد زوال المجال المغناطيسي، ما أعطى خيارهما قيمةً إضافية، جاعلاً من «كيميا» مسرحية موقف مثَّل فيه الرجل والمرأة «الإرادة المجردة» ضمن موقف شمولي ألقى الضوء على ظرف إنساني يعنى بوضع الجنس البشري ككل، لا بحالة المجتمع بإطاره الضيق فقط.
المصيدة المغناطيسية إذاً كانت سبباً في تحرر إنسانين من بوتقة الزيف الاجتماعي، والبقاء على المرارات ذاتها، كالتي يعانيها «الأب.. وليد الدبس» مع «زوجته.. سلوى حنا» في حياة قضياها من دون حب، وعدم رغبة الأب في أن تكرر ابنته تجربته الأليمة، ما دفعه للوقوف إلى جانب ابنته في علاقتها الغريبة من ذاك الرجل المتزوج، ولاسيما ضمن مجتمع مملوء بالشرطة والعسس والمرضى النفسيين القادرين على تخريب توازن الحياة، لولا بعض العقلاء والمتصوفة الذين يمارسون حياتهم متسكعين كالشخصية التي أداها «مأمون الفرخ» وأعلنت حكمتها على الملأ من أنه «علينا أن ننهزم أمام الحب، لأننا بذلك وحده ننتصر».
هذه الغرابة والطرافة والألم كخلطة «غروتيسكية» أثيرية كانت خياراً متميزاً، لولا المعايير غير الدقيقة في توزيع تلك العناصر على مفاصل العمل، فالعامية التي جاءت بموازاة قصيدة «محمود درويش» الافتتاحية والختامية، مرَّت في العرض كشيء مُضحِك أكثر منها كمستوى لغوي عالٍ يقترب من حكمة الشعر، قائلُهُ يقترب في علاقته من «الأب» من علاقة راقصي الدراويش في توحُّدهم بالكون الأعظم، كما إن عُمْق الألم الذي عانته شخصية الشاب في حبِّه الضائع، نحا باتجاه كوميديا سوداء تطفو على السطح أحياناً في محاولات للإضحاك، لا تلبث أن تتحول إلى قهر مُزمِن بأداء عالي المستوى لـ«طارق» في مونولوجات استذكاراته لزهوة حُبِّه الماضي نحو نهاياته المستمرة، لتبقى أزمة الزوجة فوَّارةً بالقسوة وتقترب من الهذيان بكامل حيويته في انفعالات «نجاح»، وكأن الحقيقة لابدّ من أن تجرح الرَّاضين بالزّيف، هذه المشاعر المُتضاربة حيناً والمتوازية حيناً، واكبتها إضاءة حساسة لـ«بسام حميدي» الذي جعل من المجال المغناطيسي مربعات ضوئية، ومن الحب مسارات لونية، لا تلبث أن تتحول إلى إضاءة عامة مع تكشُّف ملامح الحُب، وفي موازاة ذلك جاء ديكور وأزياء «ياسمين أبو فخر» لتؤسس مناخاً بصرياً يوازن بين الكشف والغموض، عبر ستائر مُسدلة أمام الممثلين والتصاميم الحركية الغرافيكية التي ظهرت على الشاشة في عمق الخشبة، محققةً فضاءً سينوغرافياً ساهم إلى درجة كبير في الإمعان بكيمياء الحب ببعدها الإنساني العميق، ولاسيما في شراكتها مع الإضاءة، وموسيقا «محمد العزاوي» التي عزَّزت المناخ الكوني للحكاية وعظمة الحب، ضمن مقترح لمسرح حديث يركز على المعنى ولا يلغي الممثل كمركز العرض الأهم مهما قست عليه النهايات.
البعث
 شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل